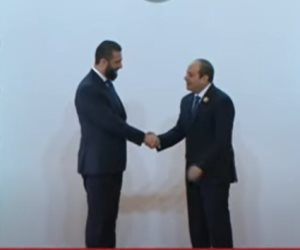الدستور.. وقدم مصر الثانية
الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:56 م
هشام السروجي يكتب:
جاء قرار مجلس النواب بإدخال تعديلات على دستور 2014، ليثير حالة زخم في الشارع السياسي، بعدما شهد جمودا نسبيا لفترة طويلة، لكن ما فاجأني، وخالف توقعاتي، هو رد فعل الجانب الرافض للتعديلات الدستورية- أقصد هنا الشباب- الذين توقعت منهم الاستمرار في انتهاج استراتيجية "التقوقع" والانغلاق على الذات، وأن يدشنوا حملة لمقاطعة الاستفتاء، مع الاكتفاء بالانسحاب من مواجهة التيار المؤيد للتعديل.
تابعت آراء بعض الأصدقاء الرافضين للتعديل على شبكات التواصل الاجتماعي، ووجدتهم ينظرون للأمر بقدر من الأهمية ويرون وجوب استغلال حالة التدافع الجماهيري، لصنع رمزية داخل الصناديق، تؤكد وجودهم في الشارع وتأثيرهم عليه، وهو تطور نوعي في التفكير أشعرني بارتياح وقدر كبير من السعادة، ففكرة الاشتباك مع الشارع، ومبارحة الأبراج العاجية، والنزول إلى الصناديق، وممارسة منافسة شريفة، هى ما ستنعكس بالإيجاب على الشارع والمواطن، فإذا تنافست التيارات المختلفة على حصد الأصوات المؤيدة لكل منها، فإنهم سيعملون بالضرورة على الاشتباك مع الشأن العام، وخلق ظهير شعبي يتبنى وجهة نظر كل فريق، من خلال تقديم رؤى واقعية تخدم تطلعات المواطن، وتنعكس على الدولة ومؤسساتها وجهودها التنموية.
التنوع والإختلاف سنة كونية، حتى أن الدين نفسه تنوعت مذاهبه الفقهية، ولم يُبن على رأي واحد، فكان شعاره الأهم أن في الاختلاف رحمة، لكنه تأسس على ثوابت لا تتزعزع، وبالتالي فإن تنوع الآراء ووجهات النظر في المواقف السياسية، مع احترام الثوابت الوطنية الراسخة، مسارات يجب أن تجد مساحتها على الأرض.
تأسست الفلسفة الصينية على أن الوجود الكوني نتاج سريان قوتين متوازنتين في كل مظاهر الحياة: "الين" و"اليانج"، اللتين تمثلان التناقضات المختلفة: السالب والموجب، الذكورة والأنوثة، الأعلى والأسفل، الصيف والشتاء... إلخ.
فبدون وجود الشئ لن ندرك معنى نقيضه، وأنه لا وجود للشيء إلا بوجود ضده، وبدون وجود مكون من المكونات وجودا قويا وواضحا، فإنك لن تدرك نقيضه، ولن تدركه هو نفسه.
كلما كانت الدولة قوية ومتماسكة، اتسعت ساحتها السياسية لكل الآراء، ومن ثمّ أرى أن مكانة مصر الإقليمية، وريادتها في ممارسة الديمقراطية، تجعلان من الواجب علينا جميعا العمل على إفساح الساحة السياسية للجميع، أو ببساطة "الملعب واسع"، وتنوع الآراء بين موافق ورافض لا يُعني خيانة الأخير للدولة أو كفره بها.
نعم.. اصابت المواطن فوبيا «المعارضة» بعد أن عانى الأمرّين جراء حالة الفوضى التي اعقبت ثورة 25 يناير، ثم موجات الإرهاب المتتالية، وسعى بكل قوته إلى مساندة مؤسسات الدولة حتى استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار، لكن هذا لا يُعني بالضرورة أن نفتح المجال لتخوين كل من يحمل رأيا آخر، بل يجب علينا وضع حد لـ"الشوفينية" والتعصب الأعمى لوجهة نظر واحدة، وتلك النوعية من الممارسات التي تدحض كل محاولات المعارضة السلمية للتعبير عن حضورها في المشهد، وهو في عمقه إثراء للحياة السياسية، يزيدها عمقا وقوة وتحضّرا وتنوعا حميدا، طالما كان في إطار العمل السياسي النابذ للعنف والتطرف والراديكالية، فسفينة الوطن تتسع للجميع.
فيلسوف علم الاجتماع الدكتور علي الوردي- شخصيًا أراه مِن أعظم مَن تناولوا وفندوا سيكولوجية العقل الجمعي للمجتمعات- يقول في كتابه "مهزلة العقل البشري"، إن: "المجتمع البشري لا يستطيع أن يعيش بالاتفاق وحده، فلا بد من أن يكون فيه شيء من التنازع أيضا، كي يتحرك إلى الأمام. إن الاتفاق يبعث التماسك في المجتمع، ولكنه يبعث فيه الجمود أيضا. فاتحاد الأفراد يخلق منهم قوة لا يُستهان بها تجاه الجماعات الأخرى. وهو في عين الوقت يجعلهم عاجزين عن التطور أو التكيف للظروف المستجدة. فالمجتمع المتحرك هو الذي يحتوي داخله على جبهتين متضادتين على الأقل، حيث تدعو كل جبهة إلى نوع من المبادئ مخالف لما تدعو إليه الجبهة الأخرى. وبهذا تنكسر كعكة التقاليد، ويأخذ المجتمع إذ ذاك في التحرك إلى الأمام".. وخلاصة هذا وما أراه من تعقيدات المشهد، أن علينا إعادة النظر في طريقة رؤيتنا للخطاب الآخر، حتى تستقيم ساقنا الأخرى، فالحكمة النهائية أنك"إذا رأيت تنازعا بين جبهتين متضادتين في مجتمع، فاعلم أن هاتين الجبهتين له بمثابة القدمين اللتين يمشي بهما".