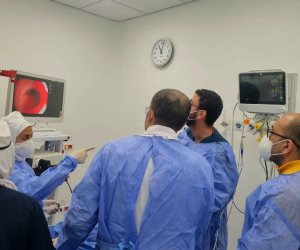كوسة.. باذنجان.. فلفل رومى
الأربعاء، 05 يوليو 2017 12:00 م
آمال الشرقاوى يكتب:
يحار المرء من أين يبدأ كلامه، حينما تتكدس الهموم فوق رأسه، لعقود، استفحلنا الجهل وغادرنا الفهم والتقييم السليم لمجرى الأمور. نشأنا وتربينا وترعرعنا وأيقنا أنه ليس لنا سلطان على الظروف. كل مصيبة تحدث لنا نفتح مسارا للجدل أياما وأياما، ويستمر الجرح ينزف إلى أن يتقيح، وتسجل المصيبة كلمات على ورق لتضاف إلى قائمة ما قبلها فى انتظار لما هو آت بعدها، وتطوى الحلول فى دائرة النسيان وتقيد ضد مجهول، والآن نبحث عن ذلك المجهول، فكيف لنا أن ندركه بعدما أصبحنا فى عداد المفقودين؟ كما الكاتب تتلاحق الأفكار داخل عقله لتزدحم الحروف داخل شرايين ذلك العقل، ولا يعنى تزاحمها عند البعض أنه قادر على الكتابة فى تلك اللحظة، فربما يلقى بالقلم جانبا أو يمزق الأوراق غاضبا ساخطا على الواقع.
تتناحر الحروف عبر تلك الدائرة الضيقة، تسعى للخروج ليتصدر حرف أكثر شراسة، يتسابق، يتصارع ليخرج قبل الآخر، وأحيانا دون ترتيب مسبق من الكاتب، لتخرج بعض العبارات مشوهة فتلاقى القبول عند البعض ويرفضها البعض الآخر. وأحيانا يتحرك القلم بسلاسة لينطلق على برارى السطور دون قيد أو شرط، يحلق بإبداع ربما لا يدركه الكاتب نفسه. القوى الكهرومغناطيسية، لربما تكون هى الفيصل فى نوعية مواضيعه المطروحة وسلامة تفكيره من عدمه ويقظة ضميره من غفوته، تتلامس أسلاك ذلك العقل، إما أن يندفع التيار الكهربائى لتشده القوى المغناطيسية السالبة إلى عالمه الخاص وحسبما يتراءى له من مصالح تخدم أهواءه الشخصية، فيتمسح بالسلطة معبرا عنها، سائرا على نهجها، ملتزما بعبارة ميكافللى «الغاية تبرر الوسيلة»، وهذا إنما نابع من تكوينه الشخصى، هذه الفئة لا تعرف للحق طريقا، ولكنها تحظى بشعبية كبيرة، وهذا إنما يدل على أهلية المجتمع بكافة تفاصيله، والبعض الآخر يتمسك بفضيلة القلم، لتشده القوى الإيجابىة معترضا عما يراه غير صائب، وغالبا ما يكون الأقل شعبية فى زمن تصدرت فيه الفئة الأكثر جهلا وتوارت الفئة الأكثر حكمة، وهناك من تأخذه القوى المغناطيسية بعيدا بعدما عجز عن ملاحقة التيار، فيتملكه الصمت بعد عدة محاولات باءت بالفشل أو يفرض عليه الابتعاد. هذا إنما ينطبق على كل أدوات الإعلام بأشكاله المختلفة، سواء السمعى أو المرئى أو المكتوب. مما لا شك فيه أن التباين فى وجهات النظر صحى ومطلوب إذا كان الهدف من ورائه مصلحة الوطن والمواطن، ولكن فى ظل كساد الأوطان، أخذ ينشط مؤخرا هذا الفكر الإعلامى المنافق والمدعى كما السرطان بعدما كان شبه كامن والتصق بأصحابه، حتى خيل لهم من كثرة أكاذيبهم أنه الحقيقة، ونجحوا بأن يدسونه فى عقول بعض فئات الشعب وخاصة بعدما تأكدوا أن العقول أصبحت خاوية. فعندما تجوع البطون تتوه العقول ولا يهم بماذا تملأ وقت الشظف والجوع، فلا تمييز بين كوسا.. باذنجان.. فلفل رومى، سواء كانت صالحة للتناول أم منتهية الصلاحية. ومع كل تلك التناقضات ونوعية الفكر، تخلق بصمة الأوطان ووصمتها، أما نحن فليس إلا مجرد أوراق جوفاء محفوظة داخل أدراج الجهل، بعشوائية الفكر والتخبط. مزاجنا لا يتسم بالهدوء، عواطفنا ليست مستقرة، نبضاتنا المتسارعة غير منتظمة، أخذنا نضل الطريق، فقد تعطلت عقارب البوصلة داخلنا بعدما أصيبت بالصدأ من حيرتنا وعجزنا، فنحن كشعوب عربية لم يعد لديها المقدرة على التمييز بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. أخذ التوهان يلقى بكل ظلاله على كل مناحى حياتنا، وأصبحنا ليس أكثر من مجرد عيون زائغة البصر لا يمدها القلب بالطمأنينة، نحبس أنفاسنا تحت أقدام المجهول.
عملوا لسنوات طوال على تعطيل قدراتنا وغزو عقولنا، وأخذ الإعلام يعرض لنا مسرحا هزليا رخيص الثمن على أرض الواقع فرض علينا مشاهدته والتفاعل معه فليس أمامنا خيارات أخرى أو بدائل، بعدما أصبحنا لقمة سائغة من السهل تقطيعها وابتلاعها من كل من حولنا، استؤجرت بعض الأقلام، وكلما ازداد ثراؤها أفلست نفوسنا، ونجحوا فى استقطاب معظم شرائح الشعب من خلال الانتهازية وليست الموضوعية. فنحن كشعوب عادة ما نعمد إلى النتائج، نطالب بالحلول ونستغيث عندما تقع المصائب، فقدراتنا أقل من أن نفكر فى علاجها عند ظهور بعض من أعراضها أو حتى نعمل على كيفية الحماية قبل ظهور تلك الأعراض. فمنذ نعومة أظافرنا تعودنا أن هناك إدارة عليا تحكم السيطرة علينا من خلال أسرنا ومجتعنا الصغير، يحكمنا كبير الأسرة وما علينا سوى الانصياع للأوامر بالسمع والطاعة، فلا بدائل ولا خيارات ولا اعتراضات، وعادة ما يلجأ كبير الأسرة أحيانا للمشورة عندما تستعصى عليه بعض الأمور وغالبا ما يختار من هو متفق مع فكره البدائى، المتحجر والخارج عن كل منطق، ويبرر تشدده هذا بأنه نابع من أجل حمايتنا ومصالحنا، وبما أننا نعيش تحت كنفه فلا مفر من الاستسلام وإلا..، والقليل منا يتمرد فيعتبرونه خارجا عن التقاليد ولا بد من قمعه، فيعين عليه مخبرين من بعض أفراد العائلة للتلصص، وتحاك المؤامرات، فنحن شعوب تعشق المؤامرة وتتلذذ بها، إلى أن اتسعت دائرتها وأصبحنا نتعرض لمؤامرات أكثر سخونة ممن يحيطون بنا وتربطنا معهم مصالح مشتركة، ومن بعض القوى الخارجية والتى درست شخصية مجتمعنا وأدركتها جيدا، ونحن فى هذا التوقيت أكثر ما نكون عاجزين على الوقوف أمامها والتصدى لها. وعندما كبرنا أخذنا نحتمى بالإدارة العليا فى الدولة، سواء كانت محقة أم غير محقة، نسير فى ركبها وعلى نفس نهج طفولتنا ونشأتنا، ولا نفرق ما بين الغث والثمين، بعدما تعودنا طوال مسيرة حياتنا على السلبية والاتكال، وحتى لو اتسم بعض الإدارات بالإيجابية، نجد أنفسنا عاجزين عن التفاعل معها والخروج من دائرة الاعتماد الكامل على الآخر، طبيعة نشأتنا هذه هى الجزء الأكبر الذى ساهم فيما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن بكل تفاصيل حياتنا وما نحن إلا نتاج بيئة، ومما يستوقفنى أنه فى بعض العقود التى مضت، كان البناء بكل جوانبه أكثر تقدما ونموا حسب إمكانيات تلك المرحلة وظروفها. وما بين هذا وذاك تصدرت أزمة الثقة وهى من ضمن أقوى الأزمات التى نواجهها الآن، فأخذنا نشهر أسلحتنا فى وجوه بعضنا البعض بكل طاقاتنا السلبية، فنحن شعوب تبرئ الباطل وتسحق الحق. فهل هناك متسع من الوقت للخروج من تلك الأزمات فى ظل وعورة الطريق أمامنا ومطباته ومصداته؟ فلا يعفى أحد منا من المسئولية،فكل منا هو المسئول بطريقة أو بأخرى.
و يبقى الحب:
* أنت مجرد جملة عارضة، اختلست اللحظة، سرقت الفرحة، اختبأت فى الدهاليز فخاصمتها الرجولة.
* زهقت روحى، فأصبح موتى فى طى الكتمان.