فقهاء مروا من هنا.. "المقريزي" موثق تاريخ مصر بعيون المراقب الناقد
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 07:08 م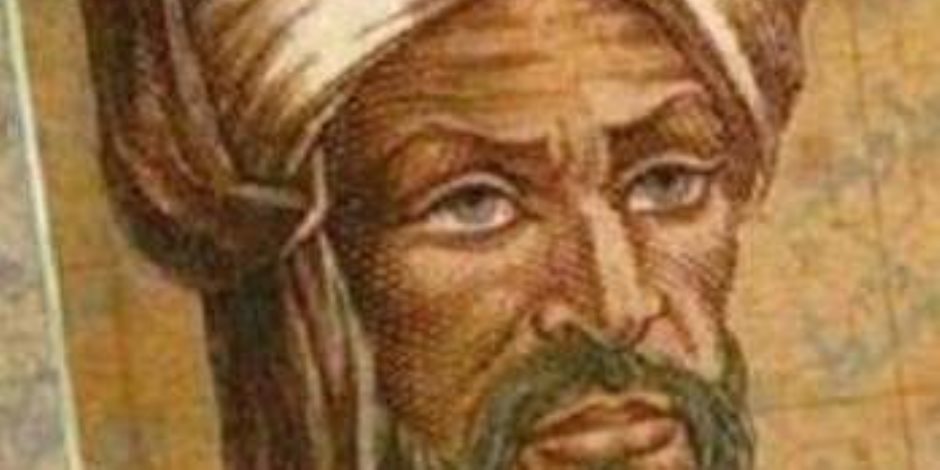
محمد الشرقاوى
- أحمد بن علي المقريزي ولد في القاهرة المملوكية واعتزَّ بمصريته القاهرية فجعلها محور كتاباته التاريخية مركزا على تحولاتها الاجتماعية والعمرانية
- درس الفقه على مذهب الحنفية وانتقل لاحقًا إلى الشافعية.. ونجح في "تطبيع" التاريخ الفاطمي داخل السياق السني
- درس الفقه على مذهب الحنفية وانتقل لاحقًا إلى الشافعية.. ونجح في "تطبيع" التاريخ الفاطمي داخل السياق السني
كانت مصر عبر تاريخها مهدًا للعلم، وحاضنةً للفكر، ومسرحًا لأعظم العقول الفقهية التي خطّت بمدادها نهج الاجتهاد والتجديد، على أرضها تعانقت المذاهب، وتلاقحت العقول، وتسابقت الأرواح في دروب المعرفة، فلم تكن محض طريقٍ عابر، بل كانت مقصدًا يقصده الساعون إلى النور، وموئلًا لمن أراد أن يغترف من بحور الفقه وأصوله، في ساحاتها علت أصوات الدروس، وفي مساجدها انعقدت حلقات الفتوى، وفي زواياها وكتاتيبها نبتت أجيالٌ حملت لواء العلم وسارت به نحو الآفاق.
مرّ من هنا فقهاء جعلوا من مصر ميدانًا للعقل والاجتهاد، وأثروا حياتها الفقهية بفكرهم المستنير، فكانت مجالسهم ملتقى للآراء، ومنابرهم منارات للهدى، اجتمع على أرضها الإمام الشافعي الذي أرسى دعائم مذهبه الجديد، والإمام الليث بن سعد الذي نافس فقهه المذاهب الكبرى، وغيرهم من العلماء الذين نقشوا أسماءهم في ذاكرة الأزمنة، ولم يكن الفقه في مصر علمًا جامدًا محصورًا في الكتب، بل كان حياةً تنبض في الأسواق والمحاكم والمساجد، حيث تفاعل العلماء مع قضايا الناس، وأعادوا تشكيل الواقع على ضوء الشريعة بروح الاجتهاد والتجديد.
ولم تكن مصر يومًا مجرد بقعة جغرافية، بل كانت قلبًا نابضًا بالعلم، تتدفق منه أنهار المعرفة لتروي عطش العقول المتعطشة للفهم، وهنا وُضعت الأسس، وهنا نضجت الاجتهادات، وهنا تلاقى الفكر بالنص، فتشكّل تراثٌ فقهيّ خالدٌ ظل على مر العصور شاهدًا على دور مصر الريادي في تشكيل الوعي الإسلامي، ومدّ جسور العلم بين الأجيال، حيث لم يكن الفقه فيها مجرد كلمات تُسطر، بل حياة تُعاش، وعلمٌ يُصاغ، وتجربة إنسانية تنبض بالحكمة والبصيرة.
هو واحد من أعظم المؤرخين الذين رصدوا التحولات السياسية والاجتماعية في عصرهم، إذ لم يكتفِ بتسجيل الوقائع والأحداث، بل تجاوز ذلك إلى التحليل العميق والاستنباط الذكي لأسبابها ونتائجها، ولم تكن كتاباته مجرد سرد زمني للأحداث، بل سعى من خلالها إلى تقديم دروس وعبر للأجيال اللاحقة، متبنيًا منهجًا نقديًا يقوم على التمحيص والبحث في جذور الأزمات التي عصفت بمجتمعه.
ويبدو أن مؤلفات جده، التي غلبت عليها المصنفات اللغوية، كانت فواتح ما قرأه في أوائل رحلته التعليمية، مما أكسبه قدرة مبكرة على استيعاب النصوص وتحليلها، وهي المهارة التي ستنعكس لاحقًا في كتاباته التاريخية.. هو المؤرخ تقي الدين المقريزي، أحد أبرز الأعلام الذين وثّقوا تاريخ مصر بعيون المراقب الناقد، المتأمل في أحوال العمران وأسباب النهوض والانهيار.
نشأ المقريزى في بيئة علمية مكّنته من التبحر في مختلف العلوم، فتفقه على مذهب الحنفية، متبعًا بذلك نهج جده العلامة شمس الدين محمد بن الصائغ، ثم تحوّل إلى المذهب الشافعي بعد مدة طويلة لسبب أشار إليه تلميذه المؤرخ ابن تغري بردي، الذي وصفه بأنه كان "ضابطًا مؤرخًا مفنّناً محدِّثًا".. فلم يكن مجرد ناقل للأحداث، بل صاحب رؤية، يرى في التاريخ أداة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، وهو ما يظهر بوضوح في تحليلاته العميقة لنظم الحكم والتغيرات الاجتماعية.
عاش المقريزي في فترة شهدت اضطرابات سياسية وتقلبات اقتصادية عميقة، وكان شاهدًا على فساد الحكم المملوكي في مراحله المتأخرة، حيث رأى كيف يؤدي الاستبداد وضعف الإدارة إلى تراجع الدول وانهيار العمران، وانعكس هذا الإدراك في مؤلفاته التي لم تقتصر على التأريخ للحكام، بل تناولت مختلف شرائح المجتمع، من العلماء والتجار إلى الصناع والفلاحين، مسلطًا الضوء على ديناميكيات التفاعل بينهم وبين السلطة.
من هو الإمام المؤرخ الفقيه؟
ولد أحمد بن علي المقريزي في القاهرة المملوكية بحارة برجوان، التي كانت من الأحياء الراقية آنذاك، ونشأ في أسرة علمية مرموقة. وأشار في كتابه "السلوك" إلى سلسلة نسبه المرتبطة بجده الأعلى إبراهيم بن محمد، الذي استقر في بعلبك، ومنها جاءت نسبة "المقريزي". وأوضح الإمام ابن حجر العسقلاني أن هذه النسبة تعود إلى حارة المقارزة في بعلبك، حيث انتقل الجد لاحقًا إلى دمشق، التي أصبحت مستقَرًّا للعائلة قبل انتقال الأجيال اللاحقة إلى مصر.
تمتعت أسرة المقريزي بمكانة علمية بارزة، إذ كان جده المحدّث محيي الدين عبد القادر من أعلام الحديث والفقه الحنبلي، وسافر بين بعلبك ودمشق وحلب وحمص ومصر لتحصيل العلم، مما رسخ حضور أسرته في الساحة العلمية. وأسهم في انتشار الحديث النبوي، مستفيدًا من ازدهار المدارس الحنبلية التي أسسها نور الدين زنكي، وكان من بين تلاميذه الإمامان البرزالي والذهبي، مما يدل على مكانته العلمية الرفيعة.
سار ابنه علاء الدين علي، والد المقريزي، على النهج ذاته، حيث نشأ في دمشق ثم انتقل إلى القاهرة، حيث شغل مناصب إدارية وقضائية، منها التوقيع السلطاني وإدارة الحسابات. ورغم عمله في الدولة، ارتبط بالعلماء، ومنهم ابن الصائغ، مفتي دار العدل وأحد أعلام الفقه الحنفي واللغة العربية. تزوّج علاء الدين من أسماء بنت ابن الصائغ، التي كانت فاضلة ذات علم وأدب، ودوّن ابنها المقريزي ترجمة لها في كتابه "درر العقود الفريدة"، مؤكدًا تميزها.
حرص الوالدان على تعليم ابنهما تقي الدين المقريزي، فشبّ في بيئة تجمع بين الفقه والتاريخ والأدب، متأثرًا بجده لأمه الذي كان واسع الثقافة. بدأ بدراسة الفقه على مذهب الحنفية، لكنه انتقل لاحقًا إلى الشافعية، لأسباب ذكرها في سيرته. لم يقتصر اهتمامه على الفقه، بل برع في الحديث والتاريخ والتفسير، وامتازت مؤلفاته بالدقة النقدية والعمق التحليلي، مما جعله من أبرز مؤرخي عصره.
اتسم المقريزي بميوله الأثرية ونزعته الظاهرية، متأثرًا بفكر ابن حزم الأندلسي وابن تيمية، فأكثر من الاستشهاد بأقوالهما وأبدى إعجابًا بطرحهما الفقهي والتاريخي. ووُصف بأنه كان محبًا لأهل السنة، يميل إلى العمل بالحديث، ويمزج بين النزعة الظاهرية والتوجه الشافعي، حتى عده بعض معاصريه أقرب إلى الظاهرية في استنباطاته وتحليله للأحداث.
ورغم انتقاله إلى الشافعية، احتفظ باتجاه نقدي تجاه الحنفية والمذاهب الأخرى، مما جعله محل جدل بين معاصريه. تأثر بالواقع السياسي والعلمي في عصره، حيث ارتبط التحول المذهبي أحيانًا بالسعي إلى المناصب الدينية، لكنه بقي مستقلًا في رؤيته التاريخية، مقدمًا قراءة تحليلية دقيقة للأحداث، بعيدًا عن التوجهات المذهبية الضيقة، مما رسّخ مكانته كأحد أعمدة الفكر والتأريخ الإسلامي.
هل هو إمام فاطمي شيعي؟
ظلَّت مسألة انتماء المؤرخ الشهير تقي الدين المقريزي إلى البيت الفاطمي محل جدل واسع بين المؤرخين القدامى والباحثين المعاصرين، فبينما ذكر بعضهم أنه من نسل الخلفاء الفاطميين، رفض آخرون هذه النسبة واعتبروها غير مؤكدة، وعلى الرغم من أن المقريزي لم ينسب نفسه صراحةً إلى الفاطميين في كتاباته، إلا أن معاصريه ومن تلاهم نسبوا إليه هذا الأصل، استنادًا إلى روايات أسرته وأقواله في بعض المواقف الخاصة.
يرى مؤرخون كبار، مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني، أن المقريزي كان يذكر هذا النسب في دوائر ضيقة، ولم يُفصح عنه في كتاباته، إلا أن بعضهم استشهد بما قاله والده عندما أخبره بأنهم من ذرية تميم بن المعز لدين الله الفاطمي، وهو ما عززه لاحقًا ابن تغري بردي عند نقله عن ابن أخيه نسبه إلى الفاطميين، غير أن هذه الروايات ظلت محل شك، خاصةً أن المقريزي نفسه أورد في كتابه "المُقَفَّي الكبير" أن تميم بن المعز لم يُعقب ذرية، ما يطرح تساؤلات حول مدى صحة الانتساب إليه.
وفي مقابل هؤلاء، هناك من رأى أن المقريزي كان متأثرًا بالفكر الفاطمي دون أن يكون بالضرورة من نسبهم، بل ربما كان تعاطفه معهم نابعًا من اهتمامه بالتاريخ الإسلامي وإعجابه ببعض مظاهر حكمهم. فقد كتب بإسهاب عن الدولة الفاطمية، خاصة في كتابه "اتعاظ الحنفاء"، الذي يُعد من أوفى المصادر حول تاريخ الفاطميين، لكنه لم يكن منحازًا إليهم بقدر ما كان مؤرخًا محايدًا في سرده للأحداث. وقد يكون اهتمامه بالفاطميين راجعًا إلى تأثره بمحيط دراسته وتعليمه، حيث تلقى العلم على يد شيوخ كانوا على صلة بمذاهب الفاطميين أو بالاتجاهات التاريخية التي لم تعادِ الفاطميين بشكل صارخ.
وإذا كان بعض المؤرخين قد أشاروا إلى أن المقريزي لم يكن يُظهر نسبه الفاطمي إلا للمقربين منه، فإن هناك من أشار إلى أنه لم يكن هناك دليل قاطع يؤكد هذا النسب، خاصة مع عدم وجود أي وثائق أو نصوص مباشرة منه تُثبت ذلك. وقد يكون نسبه الفاطمي مجرد تقليد عائلي أو رواية متوارثة دون سند تاريخي دقيق، وهو أمر كان شائعًا في العصور السابقة حيث كان النسب إلى الأسر العريقة يمنح مكانة اجتماعية رفيعة.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المقريزي لعب دورًا محوريًا في تقديم التاريخ الفاطمي إلى القراء المسلمين، وساهم في إعادة تقييم حكمهم لمصر والشام، بعيدًا عن الصورة السلبية التي رسمها مؤرخون متشددون من أهل السنة. وربما كان نجاحه في "تطبيع" التاريخ الفاطمي في السياق السني دليلاً على عمق معرفته وإدراكه لضرورة تقديم رؤية تاريخية متكاملة دون تحيز مذهبي حاد، ما جعله أحد أبرز المؤرخين الذين كتبوا عن الفاطميين بحيادية نسبية مقارنة بغيره من المؤرخين السنة الذين كانوا يرون في الفاطميين خصومًا سياسيين وعقائديين.
وفي النهاية، يبقى السؤال عن حقيقة نسب المقريزي إلى الفاطميين مسألة غير محسومة، إذ لم تتوفر أدلة قاطعة تؤكد أو تنفي ذلك بشكل مطلق. لكن ما هو مؤكد أن المقريزي قدّم أعمالًا تاريخية بالغة الأهمية حول الفاطميين، وساهم في توثيق حقبتهم بطريقة لم تسبقها أي كتابات أخرى في التراث السني.
مكانته العلمية والوظيفية
اتسم المقريزي بشخصية متزنة، فكان حسن الصحبة، سريع البديهة، ومولعًا بالتاريخ حفظًا وتدوينًا، وشهد له تلميذه ابن تغري بردي بشهرته في حياته وبعد وفاته، بينما انتقده السخاوي في الجرح والتعديل، وهو تقييم يُنظر إليه على أنه غير منصف نظرًا لنزعة السخاوي في التقليل من معاصريه. وحظي بتقدير واسع في الأوساط العلمية والسياسية، إذ كان حديثه ممتعًا، مليئًا بالنوادر، مما جعله مجلسًا لا يُملّ منه، حتى وصفه ابن شاهين بأنه جامع بين ذكر السلف من العلماء والملوك، وكانت له هيبة بين معاصريه، حتى صار معظَّمًا في الدول، حاضرًا في مجالسها.
ففي كتاباته التي تجاوزت مئتي مجلد، تميز بالدقة والأمانة والنزاهة العلمية، فكان ضابطًا للتاريخ، محيطًا بوقائعه، مستعدًا لتقبل التصحيح حتى من تلاميذه، ذكر ابن تغري بردي أنه كان يعيد النظر في كتاباته عند تقديم أدلة أقوى، مما يدل على تواضعه العلمي وسعيه للموضوعية. واتسم أسلوبه بالسلاسة والوضوح، بعيدًا عن التعقيد، حتى وصفه الحافظ ابن حجر بأنه صاحب "نظم فائق ونثر رائق"، وتعددت مصادر معرفته بتعدد شيوخه الذين بلغوا ستمئة، وانعكس ذلك على تكوينه الفقهي، حيث انتقل بين الحنبلية والحنفية والشافعية، مع ميل إلى الظاهرية، مما منحه قدرة على استيعاب مختلف الاتجاهات الفكرية في عصره.
اهتم المقريزي بالحديث النبوي، وكان من محبي أهل السنة، متأثرًا بفكر ابن تيمية الذي دافع عنه في كتبه ولقّبه بـ"شيخ الإسلام"، ورغم تأليفه رسالة "تجريد التوحيد المفيد" وفق النهج التيمي، فإنه تجنب الخوض في مسائل الصفات الإلهية التي أثارت الجدل حول ابن تيمية، وركز بدلاً من ذلك على توحيد الربوبية وآثاره الاجتماعية. كما قيل إنه جمع بين النزعة الصوفية والنقد الإصلاحي، فقدّر رموز التصوف لكنه انتقد بعض طرقه التي تهاونت في العبادات وآداب السلوك، وكتب في "المواعظ والاعتبار" عن جماعات اكتفت بالرخص وأعرضت عن التكاليف الشرعية، معبرًا عن رؤيته النقدية لتجاوزات التصوف في عصره.
وبدأ المقريزي حياته المهنية في الوظائف الرسمية اقتداءً بوالده، حيث كانت الوظائف الحكومية خيارًا مفضلاً لأسر الطبقة الوسطى في مصر، وتولى مناصب عليا في البيروقراطية المملوكية، شملت القضاء والحسبة والخطابة، باستثناء الفتوى الرسمية، وارتبط بالبلاط المملوكي عبر السلطان الظاهر برقوق، فتولى "النيابة في الحكم"، وكتب التوقيع السلطاني، وأصبح محتسبًا للقاهرة. ومارس الحسبة مرات عديدة منذ 801هـ/1398م، ما منحه خبرة واسعة في الشؤون الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، انعكست في كتاباته، تولى أيضًا الخطابة والإمامة والتدريس في مؤسسات دينية بارزة بمصر ودمشق، وعُرض عليه القضاء بدمشق لكنه رفض، عُرف بالنزاهة في كل مناصبه، لكنه اعتزل الوظائف عام 841هـ/1437م، متفرغًا للعبادة والعلم وبقي على هذه الحالة من الخلوة والانقطاع في التأليف في موضوعات التاريخ والسيرة النبوية حتى وافاه الأجل في السادس والعشرين من رمضان سنة 845هـ/1441م عن عُمر ناهز الثمانين، تاركًا خلفه إرثًا قلّما جاء به مؤرخ آخر.
مصر في عقل الإمام
اعتزَّ المقريزي بمصريته القاهرية، فجعلها محور كتاباته التاريخية، مسلطًا الضوء على تحولاتها السياسية والاجتماعية والعمرانية، دوّن تفاصيلها عبر العصور، مفصّلًا في أخبار دولها، وأعلامها، ومؤسساتها، وآثارها، حتى عدّه ابن حجر من أصحاب "التصانيف الباهرة"، خصوصًا في تاريخ القاهرة.
صنَّف المقريزي مصنفات موسوعية عن مصر، فكتب عن سكانها في «البيان والإعراب»، ودوَّن تراجم أعلامها في «التاريخ الكبير المقفَّى» و«درر العقود الفريدة»، حتى قال ابن تغري بردي عن أحد كتبه: «لو كَمُلَ هذا التاريخ على ما أختاره لجاوز الثمانين مجلدًا». كما أرّخ لحقبها السياسية في «عَقْد جواهر الأسفاط» لعصر الفسطاط، و«اتعاظ الحنفاء» لعهد الفاطميين، و«السلوك» الذي تناول حكم الأيوبيين والمماليك حتى وفاته.
وفي مجال العمران، كشف عن أزمات مصر الاقتصادية في «إغاثة الأمة بكشف الغمة»، ووثّق معالم القاهرة في «المواعظ والاعتبار»، الذي وصفه ابن تغري بردي بأنه "في غاية الحسن"، مشيدًا بدقة تفاصيله التي أعادت إحياء تاريخ المدينة، وكان المقريزي شديد الاهتمام بتوثيق الحياة اليومية، فتحدث عن الأسواق، والمساجد، والقصور، والبيوت، ناقلًا صورة حية عن مجتمع عصره. ووعى تركيبة مصر الاجتماعية، فكتب عن المسلمين وأقباطها ويهودها، متتبعًا التنوع الفكري والمذهبي الذي شهدته، ورصد مظاهر التفاعل بين المكونات الدينية المختلفة، وسلط الضوء على تطور الفكر الإسلامي في مصر، مبينًا أثره في الحياة الثقافية والسياسية.
لم يمنعه ولاؤه لمصر من نقد بعض خصال أهلها، مستندًا إلى الرؤية الخلدونية التي تربط بين البيئة وطبائع البشر. وصفهم في «المواعظ والاعتبار» بأنهم «سريعو التغير، قليلُو الصبر والجَلَد»، متأثرًا بأوضاع مصر في عصره، حيث تفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما انعكس على سلوك المجتمع. ورغم نقده اللاذع، ظل المقريزي مُكبرًا لمصر، معتبرًا إياها مسقط رأسه وموطن أهله، تمامًا كما فعل المفكر الجغرافي جمال حمدان في «شخصية مصر»، جمعهما التمجيد للوطن مع النقد الحاد لواقع مجتمعه، وكأن العزلة التي أحاطت بكل منهما جعلتهما أكثر قدرة على رؤية مصر بعين الباحث المدقق، لا بعين العاطفة وحدها.








