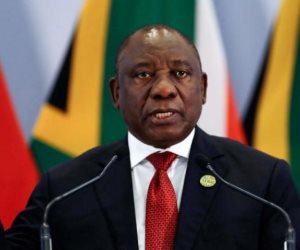دراما أبناء العاملين
الأحد، 03 يونيو 2018 09:22 ص
حازم حسين يكتب:
قبل سبع سنوات انقلبت الدنيا واشتعلت الأجواء، وتبدلت مصر من حال إلى حال، وكان في القلب من هتافات المتظاهرين ضد نظام ما قبل 25 يناير 2011، رفض ما قيل إنه مشروع يُدبر في أروقة القصر لتوريث الحكم لنجل الرئيس الأسبق، بينما على الجانب المقابل يُورث هؤلاء المحتجون مهنهم وأشغالهم للأبناء والأقارب، تحت سمع وبصر الجميع وبإقرارهم وقبولهم، ولا أحد يرفض أو يعترض أو ينتقد، حتى لو كان أداء الوارثين مهتزا وضعيفا ولا يرقى لقيمة من أورثوهم، أو قيمة المهنة نفسها.
شاع بين المصريين لوقت طويل أن المراكز الاجتماعية تنتقل بالدم والمصاهرة وصلة الرحم، وأصبح الجميع معتادين ومتقبلين لفكرة أن يشق ابن الطبيب طريقه منذ المرحلة الابتدائية إلى عيادة والده، وابن المهندس لمكتب العائلة، وأبناء الصيادلة والمدرسين والأكاديميين ورجال الأعمال والتجار والفنيين، وحتى الخارجين على القانون يرث أبناؤهم في كثير من الحالات تمردهم على النظام وكسرهم للقواعد، لهذا أصبح طبيعيا أيضا في عُرف البعض أن يرث أبناء الفنانين آباءهم وأمهاتهم في الفن، الممارسة لا الإبداع، بغض النظر عن جدارتهم من عدمها، وسواء كانوا موهوبين أم عارين من كل موهبة ومزية.
ظاهرة وراثة الفن لا يمكن التعامل معها باعتبارها ظاهرة أصيلة وراسخة في أصل الوسط، أو صيغة اجتماعية أو ثقافية أقرب إلى الأوتوقراطية وطابور العرش في الأنظمة الملكية، أي أنها قديمة قِدم الصنعة الفنية، إذ بتتبع مسار الساحة الفنية منذ تشكل أسس الصناعة واستقرار ركائزها يندر أن تجد اتصالا عائليا لحلقات العاملين في المجال، فمنذ عشرينيات القرن الماضي يمكن أن نحصي أسماء علي بدرخان الذي ورث مهنة الإخراج من والده أحمد بدرخان، وهالة فاخر التي ورثت التمثيل من والدها فاخر فاخر، ويس إسماعيل يس، وزكي فطين عبد الوهاب، ورانيا فريد شوقي، وأحمد راتب، وآخرين لا يتجاوزون أصابع اليدين، بينما تطور الأمر في السنوات الأخيرة إلى درجة أنه يندر أن تجد ممثلا من جيل الوسط لا يعمل واحد أو واحدة من أبنائه على الأقل في الفن، أما عن المقارنة بين الوارثين الأوائل والوارثين الجدد، على صعيد الموهبة والإمكانات الفنية، فلن تكون بالتأكيد في صالح الوافدين حديثا.
النظرة العميقة للأمر ربما تعود بالظاهرة إلى حقبتي السبعينيات والثمانينيات، مع بزوغ ظاهرة الانفتاح الاقتصادي وما أسبغته على البنية الاجتماعية والمهنية لمصر من قيم وعادات جديدة، ترافقت مع تنامي النزعة الاستهلاكية والنهم لمنجزات عصر الحداثة والثورة الصناعية وبشائر المعلوماتية، وهو الأمر الذي زاد من حجم الطلب على السلع الاستهلاكية، وعلى منتجات الترفيه من موسيقى ودراما وغيرهما من الفنون، ووفق هذه الصيغة التجارية الشرهة تراجعت قيم الجدارة والفرز والتقييم باعتبارها قيما حاكمة لفكرة النجاح والانتشار والاستمرار، وأصبح من السهل أن تحقق أغلب التجارب نجاحا ظاهريا خادعا، مع توفر طلب جيد عليها، لهذا كان طبيعيا أن يدخل المقاولون والتجار ومحدثو الثراء مجال الإنتاج الفني، وأن تشهد السبعينيات والثمانينيات إنتاج مئات الأفلام السطحية التافهة، التي عُرفت بـ«أفلام المقاولات»، وقتها كان العادي أن ينتهي فريق العمل خلال أسبوعين أو ثلاثة من فيلمه المعبأ على طريقة الأغذية المعلبة، ليتلقفه الحرفيون وأبناء الشرائح المتدنية بالطبقتين الوسطى والعاملة، ثم تسافر أشرطة الفيديو إلى دول الخليج، لنصبح فجأة أمام صناعة مختلفة عما درجت عليه السينما طوال تاريخها السابق، ونجوم وافدين تحت إلحاح الطلب ونهم الاستهلاك.
الحالة السابقة التي سيطرت على السينما والفنون المصرية حتى منتصف التسعينيات، ساهمت في مسخ وتشويه فكرة النجاح، وصنعت نجومية زائفة لعشرات الأسماء، وهي نفسها التي قادت لاحقا لدخول مئات من أبناء العاملين للمجال، وضمانهم المسبق للنجاح السهل الذي يغذيه الطلب، ويستر عواره وسطحيته تراجع القيم الفنية وضحالة الوعي المجتمعي، واستهلاك ميراث الذوق تحت أحذية المقاولين والجزارين وتجار الميني فاتورة.
هذه الصورة المشوهة، رغم ما فيها من سطحية وخفة، استطاعت عبور مراحل الانتقال والتوتر التي شهدتها مصر منذ منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة حتى ثورة يناير، وواصلت حضورها وازدهارها حتى الآن، ليترعرع عشرات من أبناء العاملين في حقول الفن المختلفة، ويكتسبوا مكانة معنوية ونجومية هشّة، صنعتها حالة الرواج الاستهلاكي، وتراجع الدولة عن الإنتاج المباشر للسلعة الفنية، وانفتاح الساحة مع تحلل قبضة الرقابة جزئيا، وتنامي الطلب مع اتساع حيز العرض وزيادة عدد القنوات وشاشات السينما وتضخم الجمهور المستقبل لهذه المنتوجات، وأيضا تحولات القوى الشرائية التي أحدثتها التقلبات المتتابعة وأنماط الاقتصاد وعلاقات القوى داخله، ليتركز جانب كبير من القوة الشرائية في أيدي الحرفيين وأبناء الطبقات البسيطة اجتماعيا والمهمشة ثقافيا، صانعين موجة جديدة من الطلب الموجه في اتجاه محتوى ودراما ونوعيات أبطال ونجوم، لا تختلف فقط عن ميراث الفن المصري، وإنما لا تعبر بشكل حقيقي عن طبيعة المجتمع وصورته الحقيقية.
الآن، ونحن في قلب موسم الدراما السنوي الأول، بقائمة عرض تقترب من 30 مسلسلا تعرضها عشرات الشاشات داخل مصر وخارجها، يمكن إحصاء أسماء عشرات من أبناء الفنانين، من كبار النجوم والأسماء المتوسطة، ينتشرون في كثير من الأعمال، بأدوار ومساحات ترسخ حضورهم وتسبغ عليهم النجومية السهلة، بينما قد لا يصمد كثيرون منهم أمام الاقتراب النقدي الجاد، والفرز الحقيقي، والتقييم العميق لحدود مواهبهم وإمكاناتهم وما يضيفونه لهذه الأعمال أو يخصمونه منها، وربما بمعايير الإنصاف ومحددات الفن نكتشف أن أغلبهم يمثلون أعباء مضافة لهذه الأعمال، وحضورا ضاغطا على جمالياتها وفنياتها، وبطبيعة الحال على ميزانياتها وحق المتلقي النهائي في متابعة عمل متماسك وجيد فنيا، بعيدا عن محكات العلاقات الشخصية ودوائر الصداقة والقرابة وروابط الدم، التي قد تمنح فرصا مجانية للبعض لمجرد أن القدر اختار لهم مسارا عائليا يتصل بأحد الفاعلين أو البارزين على الساحة الفنية.
بعيدا عن الأسماء، حتى لا يبدو الأمر موجها لأحد بعينه، وكي نفلت من تأويلات الشخصنة، انتصارا للفكرة العميقة في جوهرها الصافي، فمن التجني بالطبع أن نمد الخط على استقامته للنهاية، إذ إن قائمة أبناء الفنانين لا تخلو من موهوبين ومستحقين، ويمكن في هذا الصدد أن نشير إلى حنان مطاوع، وأحمد سعيد عبد الغني، ودنيا وإيمي سمير غانم، وآخرين غيرهم، ولكن على الجانب الآخر يمكن إحصاء أضعاف هؤلاء الموهوبين من أبناء الفنانين أيضا، الذين حازوا فرصا ضخمة، ليس لأنهم موهوبون أو مستحقون، ولكن لأنهم أبناء عاملين فقط، بينم لا يملكون حظا من الحضور واللياقة الفنية، وإطلالاتهم رمادية أو محايدة، بلا لون أو طعم أو رائحة، أداء بارد وتعالٍ في التعامل مع الشخصيات الدرامية وانفعالات من زجاج وثلج، ويتحركون في فضاءات المشاهد كأنهم قطع اكسسوار محمولة على عجلات، وكثيرون منهم يخسفون بالمشاهد وإيقاعها الأرض، ويريقون دماء الدراما مع إراقة أرواح الشخصيات، وإراقة وعي وذائقة المتلقين أيضا.
ما لا شك فيه أن أي فرصة تذهب لغير مستحقيها، تعني في المقابل أن مستحقا خسر فرصته، وفي الوقت الذي تُخرّج فيه المعاهد الفنية وأقسام الفنون مئات من الموهوبين والدارسين سنويا، ربما يكون أبناء العاملين من الفنانين والفنيين الأقل استحقاقا لهذه الفرص اللامعة، وبالتأكيد لا يمكن بأية حال إقرار أن تكون الوراثة معيارا حاكما لإدارة صناعة الفن والدراما، وطالما كانت الروابط العائلية وتركيبة الاسم هي الحاكمة لكثير من علاقات الوسط الفني، فسنظل في أسر «دراما أبناء العاملين»، وهنا تتراجع الموهبة والجدارة والدراسة وكارنيهات النقابات الفنية، وربما تكون البطاقة الشخصية جواز العبور للوسط الفني مستقبلا.